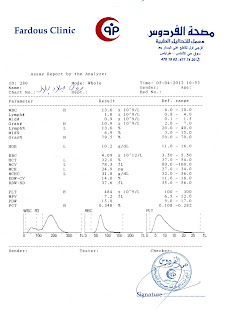بنتاي، طفلتان أرى فيهما وأمهما وقود اجتهادي وعملي لدنياي، لُوَّعْتُ بمرضهما المتكرر هذه السنة، ليشترك الشتاء، والقمامة –وربما أشياء أخرى- في إقعادهما أكثر من مرة، والمشكلة المتكررة دوما هي: أثق في الله، ولا أثق في الطب الليبي، تَرِكَةُ سنوات الظلام.
مرض ابنتي الصغرى مؤخرا كان استثنائيا، توقفت عن إشاعة الضحك بيننا كعادتها، تلك الطاقة التي كنت أتعجب صدقا من عدم نضوبها نهاية النهار لننعم بانتقال سلس من سلطة المعاش إلى سلطة اللباس، أرعبني ما استبد بها من خمول، فانطلقت على عجل يوم الأربعاء لأبحث عن رابع المستحيلات: دكتور يعرف ما يفعل، ووجدت من استبشرت خيرا على يديه لساعات انتهت بعد منتصف الليل، ولن أستطيع تقييم السبب أهو كفاءة أم تفاعل للمرض أسرع من أداء الطبيب.
النتيجة، تغيب عن عملي يوم الخميس لأسابق الزمن من منتصف النهار وحتى الساعة الرابعة، مبتدأ بالتنطع والانتقاء بين المصحات، ومنتهيا بالتوسل لأيٍ منها، لأنه ووبساطة: لا وجود لمصحة في طرابلس قادرة على إيواء مرضى، خاصة من الأطفال.
هذه هي الحقيقة التي لم أعلمها إلا الأمس، فمن مصحة المسرة التي أقرت فيها الطبيبة بضرورة إيواء ابنتي بمكان يمكن فيه متابعة حالتها مع التغذية العاجلة المتعذرين بالمصحة، إلى التنقل بين المصحات كلها بلا استنثاء تقريبا، المختار، الرازي، السرور، الأخوة، الهلال، الجلاء، إلى توقف مؤقت بإحداها منحت مخفض الحرارة والتغذية، لتتحسن حالتها جزئيا قبل أن تتدهور، آلام هائلة بملامحها وتقلص وزرقة وبرودة في أطرافها دفع الطبيبة لنصحي بالتوجه إلى أحد ثلاث أماكن مؤهلة لاستقبال حالتها، الطبي والخضراء والجلاء، واستمر مسلسل التخبط والبحث لأجد طابورا هائلا في مستشفى الخضراء بلا تنظيم رغم وجود ترقيم شكلي لا أحد يعتد به، هاتف سريع لأحد زملائي لأتشجع وأقدم آخر تنازل توقعته وأتوجه إلى مركز طرابلس الطبي الذي كنت أعتبره ملاذ من لا ملاذ له، ومستقر الخروج من الدنيا.
وقت يشير إلى بعد منتصف الليل، جري بين الممرات، ازدحام جزئي قرأت فيه اشتراك الآخرين معي في تخوفي من المكان، لكن الحقيقة المرعبة ذاتها أقرها مستند مثبت على باب عيادة الأطفال: عدم قدرة المستشفى على قبول الإيواء بعلم الوزارة.
أطفال كثيرون يسعلون، أهل مثقلون بالخوف والتعب والرعب والترقب، تنتهي الأحاديث عن الفيدرالية وعما شابهها لتنحصر الهموم في طفل تستطعم في عجزك معه مرارة العلقم، لتلعن القذافي بكل كيانك وتتمنى لو كنت من أمسك به لتكون مرسله إلى جهنم.
صبر، فعد تنازلي للدور للعلاج، فكلمات مبعثرة وتقارير تروي حالة ابنتي، حمام سريع بارد لها لتخفيض حرارتها قبل البدء في علاجها، عجز في نوع كيس التغذية المناسب لحالتها لتعويض نقص الصوديوم، لكن شيء أفضل من لا شيء ما دام غير ضار لحالتها، عيون الطبيب تبحلقان فكادتا أن تغادرا محجريهما وهو يهتف: لا حول ولا قوة إلا بالله، وفقا للأوراق التي جلبتها معك، ابنتك حقنت بمخفض حرارة غير مناسب لسنها هو سبب تدهور صحتها، تسبب هذا الخطأ في مقتل فتاة في مستشفى (خ).
لا تعليق مناسب على عبارته فليس هذا وقته، وقت مر على والدتها وعلي كدهور ونحن نتأمل قطرات سائل التغذية تنساب عبر جسدها داعين الله أن يلطف بها وبنا، وما يشبه الانهيار دفعني للأتيان بما كنت أستهجنه من غيري سابقا، لأتوسد المقاعد الحديدية وأغيب عن الوعي مرات عدة، أستفيق وأتوجه إلى حجرة التغذية، أم ريان (زوجتي) تحاكي فعل بدن رؤى لتتحسن بتحسن حالتها أمامها، عودة للتهالك على المقعد الحديدي، حماتي وشقيق زوجتي، ثم أخي، يشاطروننا الهم والمكان.
خاطر يستبد بي بإلحاح: أين هذه الكارثة من الإعلام؟ وأين هو منها؟ جائحة تصيب أطفالنا بنزلة معوية واحتقان اللوزتين والإسهال والقيء والتهاب الصدر والحرارة لتمتليء وتغص أقسام الإيواء دون إشارة واحدة إلى ما يحدث؟ هل أنا الأب الوحيد الذي (يتعاطى) الإعلام وفيسبوك في ليبيا كي أتحدث وأثير المسألة ضمن أسوأ تجربة أبوية أحياها؟
الساعة تشير إلى الثامنة عندما استفقت على صوت زوجتي لأعلم أن عبوة التغذية قد انتهت على ما يرام، وأن وقت المغادرة قد حان، تقرير أخير من طبيبين يقرران فيه ضرورة عدم منح ابنتي مضادا حيويا، والاكتفاء بمنحها أكياس مضاد للبكتيريا والإسهال، ومحاولة إطعام ابنتنا على مهل، عبارات شكر وجهتها بشكلي (المتبهدل) للدكتور (متبهدل الشكل أيضا).
قرار نهائي مني بمغادرة ليبيا إلى تونس للاطمئنان على رؤى وريان أيضا لأنها سبقت أختها في المرض ذاته ولم تشهد سوء حالتها، قرار أعلم أنه ضد ظروف عملي العام والخاص، لأن الشركة التي أعمل بها تمر بمرحلة صعبة، والعمل (على قفا من يشيل)، لكن الغاية (تأمين حياة أسرتي) أهم من الوسيلة (تعطيل وسيلة التأمين مؤقتا، أي عملي في الشركة).
سؤال لك يا د.فاطمة الحمروش: هل تنتظرين أن يصاب لك قريب حتى تدركي حجم الكارثة؟
وسؤال لكم يا من ترون أنفسكم مهمشين من خارج طرابلس: أما زلتم تعتقدون أننا نعيش في دبي؟